
الاضطرابات السلوكية والانفعالية
Behavioral and emotional disorders
بقلم: أ. منيره جاسم السديري
عند الحديث عن الاضطرابات السلوكية والانفعالية، فإن ذلك يشمل أفراداً عاديين تظهر لديهم الاضطرابات السلوكية والانفعالية في فترة ما من فترات حياتهم، نظراً للظروف البيئية المحيطة بهم إلا أن ذلك لا يعني أنهم مضطربون، لذلك يجب قبل تسمية الاضطراب السلوكي والانفعالي أو تصنيفه لدى الفرد الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التالية: تكرار السلوك، وشدته، ومدته.
تعريف الاضطرابات السلوكية والانفعالية:
ظهر عدد من التعريفات من قبل التربويين والأخصائيين النفسيين ويعود عدم وجود تعريف واحد متفق عليه بشكل عام إلى تعدد التخصصات التي اهتمت بهذه الفئة وبالرغم من اختلافات التعريفات إلا أنها تتفق على أن الاضطرابات السلوكية والانفعالية تشير إلى:
- الفرق بين السواء واللاسواء هو فرق في الدرجة لا فرق في النوع.
- المشكلة مزمنة وليست مؤقتة.
- السلوك يعتبر مضطربا وغير مقبول وفقا للتوقعات الاجتماعية والثقافية.
ومن أمثله هذه التعريفات أن السلوك المضطرب بصفة عامة هو النمط الثابت والمتكرر من السلوك العدواني أو غير العدواني الذي تنتهك فيه حقوق الآخرين أو قيم المجتمع الأساسية أو قوانينه المناسبة لسن الطفل في البيت أو المدرسة ووسط الرفاق وفي المجتمع، على أن يكون هذا السلوك أكثر من مجرد الإزعاج المعتاد أو مزاحات الأطفال (يوسف، 2000).
تصنيف الاضطرابات السلوكية والانفعالية:
قام كوي بعمل تصنيف يعتمد على تقدير الوالدين والمعلمين للسلوك وتاريخ الحالة واستجابة الطفل إلى قوائم التقدير ويتألف التصنيف من أربع أبعاد وهي:
- اضطرابات التصرف (عدم الثقة بالآخرين).
- اضطرابات الشخصية (انسحاب – قلق – إحباط).
- عدم النضج (قصر فترة الانتباه – الاستسلام – الأحلام)
- الانحراف الاجتماعي (السرقة – الإهمال – انتهاك القانون) (يحيى، 2000).
أسباب الاضطرابات السلوكية والانفعالية:
تناول العديد من الباحثين مختلف التفسيرات للعوامل والأسباب التي تقف خلف المشكلات أو الصعوبات الانفعالية والاجتماعية لدى الطلاب ذوي صعوبات التعلم.
وتنقسم هذه الأسباب إلى ثلاثة أقسام:
1- العوامل البيولوجية:
تشتمل العوامل البيولوجية على العوامل الجينية، والعوامل البيوكيماوية، والعوامل العصبية. ومن المتوقع أن تكمن وراء السلوك المضطرب عوامل بيولوجية، ولكن الحقيقة هي أن البحث العلمي لم ينجح إلا في حالات نادرة في تقديم أدلة على أن السلوك المضطرب ناتج عن أسباب بيولوجية محددة، فالغالبية العظمى من الأطفال المضطربين سلوكيا يتمتعون بصحة جسمية جيدة (الخطيب والحديدي، 1997).
2- العوامل النفسية:
تشير الدراسات إلى وجود عدد من العوامل النفسية التي تسهم في حدوث اضطراب تشتت الانتباه والنشاط الزائد ومنها الضغوط النفسية والإحباطات الشديدة، وقد تلعب عمليات التدعيم أو التجاهل دورًا مهمًا في ترسيب هذا الاضطراب.
3- العوامل البيئية:
يندرج تحت مفهوم العوامل البيئية ثلاث بيئات أساسية لها تأثير مباشر على السلوك الإنساني:
أولها: البيئة الاجتماعية بما فيها من عادات وتقاليد ولوائح ونظم وإمكانيات اقتصادية وثقافية وعلاقات بين الطبقات والأجناس المختلفة داخل المجتمع.
وثانيها: البيئة الأسرية المتمثلة بالأب والأم والإخوة، وطبيعة العلاقة القائمة بينهم وتأثيرها على النمو الشخصي للطفل.
البيئة الثالثة: فهي البيئة المدرسية المتمثلة بالعلاقة القائمة بين الطفل من ناحية وبين زملائه ومدرسيه، وبالمناهج والأنشطة واللوائح المدرسية من ناحية أخرى (السرطاوي وسيسالم، 1992).
خصائص المضطربين سلوكيًا وانفعاليًا :
النشاط الزائد:
يقصد بالنشاط الزائد أو الإفراط بالنشاط قيام الطفل بنشاط حركي مفرط لا غرضي أو بلا هدف في الغالب ويكون مصحوبا بقصر سعة الانتباه لدى الطفل وسهولة تشتته ويتصف سلوك الطفل غالبا بأنه أخرق أو أحمق (الزيات، 1998).
التحصيل الدراسي:
أشارت معظم الدراسات إلى أن التحصيل الدراسي للمضطربين سلوكيا يعتبر منخفضًا إذا ما قورن بالتحصيل الدراسي للأطفال العاديين، بالإضافة إلى ذلك فقد لاحظ عدد من التربويين إن هناك ارتباطا قويًا بين صعوبات التعلم والاضطرابات السلوكية (السرطاوي وسيسالم، 1992).
السلوك العدواني:
السلوك العدواني والتخريبي من أكثر الخصائص النفسية للأطفال المضطربين سلوكيا شيوعا. فعلى الرغم من أن استجابات العنف والعدوان تنبثق كوسائل لحل المشكلات في المراحل العمرية المبكرة لدى جميع الأطفال، إلا أنها تحدث بشكل مبالغ فيه لدى الأطفال المضطربين سلوكيًا وتبدو أشكاله في العدوان اللفظي، العدوان المادي، الصراخ في وجهه الاخرين، العناد، النشاط الزائد، إيذاء الذات (يحيى، 2000).
التشتت وعدم الانتباه:
يجد بعض الطلاب ذوى صعوبات التعلم مشكلات وصعوبات في استمرار التركيز على المثير الهدف أو النشاط، عندما تتداخل معه أنشطة أخرى منافسة في نفس المجال البصري أو السمعي، حيث يسهل تشتت هؤلاء أو افتقادهم الانتباه أو التركيز.
وتشير نتائج تحليل (25) دراسة تناولت الأنماط السلوكية لذوى صعوبات التعلم داخل الفصول المدرسية، مقارن بأقرانهم من غير ذوى صعوبات التعلم، إلى دلالة الفروق بينهم في تشتت الانتباه (الزيات، 1998).
السلوك الانسحابي:
جاءت نتيجة دراسة (Bender & Smith، 1990) إلى أن السلوك الانسحابي هو نتيجة لفشل الطلاب في إجراء أي تفاعل اجتماعي وشعورهم بالافتقار إلى القدرة على منافسة اقرأنهم بسبب تكرار فشلهم الأكاديمي.
وقد يتجه البعض من ذوي صعوبات التعلم إلى الوحدة والعزلة الاجتماعية، وقد يؤدي هذا إلى عدم القدرة على التفاعل إيجابيًا مع أقرانه أو مع الكبار ممن يتعاملون معه (يحيى، 2000).
القلق:
يعتبر القلق سببًا أساسيًا لمعظم الاضطرابات السلوكية لدى الاطفال، وأن الأطفال القلقين غالبًا ما يطورون نماذج سلوكية متعددة ينظر إليها على أنها مضطربة، وإنها مصدر لعدم السعادة الشخصية، وإنها تعيق الوظائف العقلية والاجتماعية، وتجعل الفرد يدور في حلقة مفرغة مما تجعله غير متكيف اجتماعيًا (السرطاوي وسيسالم، 1992).
انخفاض أو ضعف مفهوم الذات:
يغلب على الطلاب ذوي صعوبات التعلم أن يكونوا أقل ثقة بذواتهم، كما يفتقرون إلى مفهوم إيجابي للذات، وقد وجد إن مفهوم الذات لدى الطلاب ذوى صعوبات التعلم منخفض عن مفهوم الذات لدى أقرانهم من الطلاب العاديين، كما لوحظ إن مفهوم الذات يرتبط على نحو موجب بالتحصيل الأكاديمي. ومعنى ذلك أن الطلاب الأقل تحصيلا يميلون إلى أن يكونوا من ذوي مفهوم الذات المنخفض (الزيات، 1998).
سوء التكيف الاجتماعي:
يرتبط سوء التكيف الاجتماعي بعدم الامتثال للقوانين، والتعليمات أو النظم الاجتماعية، وتجاوز حدودها، والقيام بالأفعال التي يرفضها المجتمع، والاعتداء على التعليمات المدرسية أو غيرها. فالفرد الغير متكيف اجتماعيًا في نزاع دائم مع القيم التي يجب التعامل معها واحترامها في المجتمع والمدرسة. ولقد استخدم مصطلح الانحراف الاجتماعي للدلالة على سوء التكيف الاجتماعي (السرطاوي وسيسالم، 1992).
الاعتمادية:
يكتسب العديد من الأطفال ذوى صعوبات التعلم الإفراط في الاعتمادية أي زيادة الاعتماد على الآخرين كالآباء والمدرسين وغيرهم عن طريق طلب مساعدات غير عادية أيا كانت طبيعة الأنشطة التي يمارسونها، ودائمًا يتعلل هؤلاء الأطفال بعجزهم أو عدم قدرتهم على ممارسة الأنشطة التي يمارسها أقرانهم، متقمصين الإحساس بالعجز أو العجز المكتسب أو الإفراط في الاعتمادية (الزيات، 1998).
مظاهر الاضطرابات السلوكية والانفعالية :
1- عدد قليل من الأصدقاء أو بدونهم.
2- اضطراب العلاقات مع المعلمين.
3- النشاط والحركة الزائدة.
4- العدوان نحو الذات والآخرين.
5- التهور.
6- القلق.
7- الاكتئاب.
8- عدم النضج الاجتماعي.
9- العناد المستمر وعدم الطاعة.
10- الجنوح مثل : السرقة والعدوان المادي واللفظي.
11- سرعة الغضب والغيرة الزائدة.
12- الخجل والحساسية الزائدة.
13- زيادة أحلام اليقظة (يوسف، 2000).
المتغيرات ذات العلاقة بالاضطرابات السلوكية والانفعالية :
الجنس :
هناك علاقة بين متغير الجنس والمشاكل السلوكية فقد أشارت العديد من الدراسات التي تناولت العدوان الموجه نحو الأقران إلى أن الذكور أكثر عدوانًا من الإناث كما أن اختلاف أساليب المعاملة الوالدية تجاه الطفل تشجع السلوك العدواني عند الذكور وعدم استحسانه عند الإناث الأمر الذي يؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية لدى الذكور أكثر منها لدى الإناث .
الإنجاز الاكاديمي :
نجد ان العلاقة وثيقة بين مشاكل السلوك والتحصيل الاكاديمي فعندما يكون الطالب مضطرب سلوكيًا غالبًا ما يكون منشغلاً عن الدرس وبالتالي يؤثر ذلك في تحصيله الأكاديمي، وقد يكون ضعف التحصيل ناتج عن مشاكل سلوكية تتعلق بالتلميذ نفسه أو المعلم أو الظروف البيئية .
الصفات الجسمية :
اختلاف الصفات الجسمية بين الجنسين لها الأثر في ظهور المشاكل السلوكية فنجد خشونة الذكر تجعله معرض للمشكلات السلوكية أكثر من الأنثى.
الذكاء :
أن مشاكل السلوك لا تقتصر على الذكاء المنخفض فحسب وإنما الذكاء المرتفع كذلك، فالذكاء المنخفض يجعل الطفل بطئ التعلم والناس يعاملونه على قدر مستواه العمري لا على قدر مستواه العقلي فيطالبونه بأشياء قد تكون فوق طاقته، وقد يتعرض إلى فشل وإحباط يجعله يشعر بخيبة الأمل والقلق، كما أن الطفل المتميز بالذكاء المرتفع والذي يتميز بسمات شخصية كالاستقلالية والتفكير الناقد، وحب الاستطلاع والفضول العقلي قد يكون عرضة إلى عدم التوافق بسبب اصطدام هذه السمات بأساليب والدية غير سوية في البيت وعدم تقبل من قبل المعلمين في المدرسة .
الطبقة الاجتماعية :
لكل طبقة اجتماعية تقاليدها وثقافتها الخاصة بها والتي تؤثر في أساليب التنشئة حيث أن الآباء الذين ينتمون إلى المستويات الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة لا يعاقبون أطفالهم، بما ينتج عن سلوكهم بل يحاولون معرفة الدوافع التي أدت لذلك، وهذا يؤدي بالآباء لمناقشة أطفالهم مناقشة عقلية لمعرفة دوافع سلوكهم وأسبابها، حتى يصدروا الأحكام في ضوء تلك المناقشة. لذا نجد الحوار بين آباء وأبناء هذا المستوى يكثر، ويقل في المستويات الدنيا (الظاهر، 2005)
الوقاية من الاضطرابات السلوكية والانفعالية:
يمكن منع حدوث الاضطرابات السلوكية والانفعالية من خلال طريقتين:
- منع حدوث الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه الاضطرابات.
- علاج الفرد والعائلة.
- تعليم العائلة طرقًا جديدة في التفاعل مع الطفل.
- التدريب الذاتي.
- التعليم الأخلاقي.
- التدخل الطبي.
علاج الاضطرابات السلوكية والانفعالية:
تعتمد معالجة الاضطراب السلوكي على نوع ومدى شدة أو خطورة الاضطراب.
ويتكون العلاج من:
- العلاج الطبي.
- العلاج السلوكي.
- العلاج التربوي.
- العلاج الأسري.
دور الأسرة في بناء الشخصية السوية للأبناء:
- يلعب المناخ الأسري دورًا مهمًا في تنمية قدرات الطفل، حيث يحقق المناخ الملائم أهم مطالب النمو النفسي والاجتماعي. لأن الطفل في ظل هذا المناخ يتعلم التفاعل الاجتماعي، ويتعلم المشاركة في الحياة اليومية، وكذلك يتعلم ممارسة الاستقلال الشخصي.
- الطفل في جميع المراحل السابقة نجده متأثرًا بالأسرة، وتمثل الأسرة الوسيط الذي ينقل كل المعارف والخبرات التي تسود المجتمع بعد أن يترجمها إلى أساليب عملية في تنشئة الأبناء متمثلة في توفير المجال الكافي لمتابعة ميولهم وهواياتهم داخل المنزل وخارجه، ومناقشتهم في الموضوعات التي تهمهم، وتشجيعهم على الاطلاع.
- إن حب الوالدين أحدهما الآخر ولولدهما من أوجب بواعث الأمن في نفس الطفل، إذ تحتل الأم مكان الصدارة من وجود الطفل خلال طفولته، بل إنها تشكل عالمه كله، فإذا ما غمرت الأم طفلها بحبها الدافئ وحنانها شعر بالأمن والاطمئنان.
- مع اشتداد ساعد الطفل يصبح لأبيه الدور الأكبر في توفير الأمن له وبدخوله المدرسة يكون من واجب المعلمين خلق جو من الإحساس بالأمن والطمأنينة في قلوب الناشئة.
- إن الطفل الذي يطيع كل أمر يصدره الأب أو الأم قد يكون مريحًا، ولكنه سيكون طفلاً جامدًا، لا بد من توافر جو من التعاون والتفاهم في البيت من أجل تحقيق الغايات التي تسعى إليها الأسرة، وهي القضاء على المشكلات السلوكية التي تواجه الأطفال، والإسهام في حل كل هذه المشكلات بما يضمن للطفل النمو السليم والمتوازن، لكي يكون مستقبله مشرقًا.
المراجع:
- الخطيب والحديدي (1997)، المدخل الي التربية الخاصة، ط1، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت.
- الزيات، فتحي مصطفى (1998)، صعوبات التعلم، الأسس النظرية والتشخيصية والعلاجية، سلسلة علم النفس المعرفي، ط1، القاهرة: دار النشر للجامعات.
- السرطاوي، زيدان أحمد وسيسالم، كمال سالم ،(1992)، المعاقون: أكاديميا وسلوكيا : خصائصهم وأساليب تربيتهم، صعوبات التعلم، التخلف العقلي الاضطرابات السلوكية، ط2، مكتبة الصفحات الذهبية، الرياض.
- الظاهر، قحطان أحمد (2005)، مدخل إلى التربية الخاصة، ط1،دار وائل للنشر، عمان.
- يحيى ، خولة أحمد ( 2000) ، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان ،الأردن.
- يوسف، جمعة سيد ( 0 200 )، الاضطرابات السلوكية وعلاجها،ط1، دار الكتب الحديثة، القاهرة.
الحقوق محفوظة لـ أ. منيره جاسم السديري
ماجستير التربية الخاصة صعوبات التعلم، كلية التربية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

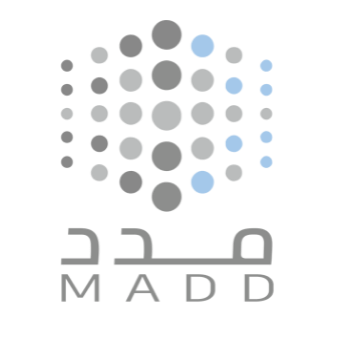

بارك الله فيك وينفع الله بعلمك
مقال جدير بالاهتمام من ذوي الاختصاص و خاصة الجهات التعليميه
بارك الله فيك
مقال رائع.. شكرا
مقال في القمة…. بوركت